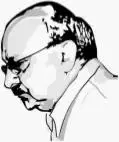سوريا... فرضية إعادة الإعمار بلا مساعدات دولية
يمثّل موضوع إعادة الإعمار لما بعد الحروب موضوع بحثٍ أكاديمي غنيّاً جداً، وهناك -حرفياً- آلاف الأبحاث الأكاديمية والاقتصادية التي تحاول تغطية الموضوع ومعالجة قضاياه. نحن هنا نريد التركيز على حالة واحدة محددة، حالة إعادة الإعمار لبلد ومجتمع مهدّم داخلياً ومدمّر مع فرضية عدم وجود مساعدات خارجية مالية أو اقتصادية. إنها فرضية حاجة الدولة المعنية إلى القيام بأعباء إعادة الإعمار مع افتراض عدم توافر دول غنية راعية أو داعمة تقدم قروضاً مالية ضخمة أو استثمارات سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات الدولية. إنها حالة افتراضية، ويمكن القول نظرية، ولن ندخل في سياق التحديدات التفصيلية والعملية للمسألة من أجل تضييق نطاق البحث.
وهناك فرضية أساسية تستند إليها المقالة، ألا وهي أن القطاع المركزي في الاقتصاد الحديث لأي مجتمع ولأي دولة بغض النظر عن حالة اقتصادها الكلي (في حالة ازدهار أو مدمر) هو القطاع المصرفي؛ القطاع المصرفي، مأخوذاً في أوسع معانيه، شاملاً كل المؤسسات المعنية بإدارة الكتل المالية والنقدية (بأشكالها كافة كنقد مباشر أو سندات...إلخ) في الدولة المعنية، سواء أكانت مؤسسات خاصة من مصارف وبنوك وشركات أسواق مالية... أم مؤسسات عامة مثل المصارف المركزية والاحتياطية.
في الاقتصاد الحديث، القطاع المصرفي هو قاطرة العجلة الاقتصادية، هو القطاع الريادي والمركزي، وبه يتركّز عصب الاقتصاد الحديث: رأس المال. أقل الإجراءات وأبسطها على هذا القطاع من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد ككل ولنتائجها تشعبات تؤثر بشكل مفصلي على القطاعات الاقتصادية كافة في البلد المعني، وكقاعدة عامة كيف يكون هذا القطاع سيكون الاقتصاد كله. ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق الطبيعية عند الحديث عن عملية إعادة إعمار حقيقية هي القطاع المصرفي، حيث يتركز رأس المال المالي، أي رأس المال بشكله المالي السائل والنقدي والذي من شأنه أن يوجه الاقتصاد ككل في البلد المعني. المعادلة بسيطة: بلد مدمر، ويحتاج إلى إعادة إعمار ذاتية، وعندما نقول ذاتية فنحن نقصد هنا حقيقية، ولا مجال للمجاملات والإصلاحات الشكلانية والخارجية والتجميلية! في مثل هذه الحالة تكون البداية بمجموعة الإجراءات والاقتراحات التي تخص القطاع الأكثر مركزية وجوهرية في هذا الاقتصاد حيث يكون للإجراءات نتائج جدية وحقيقية إذا ما تم اتخاذها.
لا ريب أن ترمومتر التحكم الحقيقي في القطاع المصرفي (والذي يتحكم بدوره في الاقتصاد الكلي) هو معدلات الفائدة (النسبة التي تدفعها المصارف والبنوك لعملائها على الإيداعات التي يتم وضعها فيها). لن ندخل أبداً في تحديدات تفصيلية، سنبقى في إطار المعادلات العامة التي تحدد الاقتصاد الكلي، أي سنبقى في إطار المقولات الاقتصادية البديهية إن صح التعبير. رفع معدلات الفائدة يعني زيادة الإيداعات. إن كتلة السيولة النقدية الموجودة في السوق سوف تتجه إلى المصارف بشكل رئيسي للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة على الإيداعات. في حالة رفع معدلات الفائدة تنسحب كتل مهمة من السيولة النقدية بشكل حتمي من سوق السلع والاستثمارات التجارية والصناعية نحو السوق المالية، لتشارك في المرابح العائدة من معدلات الفوائد المرتفعة. وهذا طبعاً ما ستترتب عليه نتائج رئيسية، أهمها: تفريغ فقاعات التضخم الكارثية والتي هي أسوأ تركات الحروب وأثقلها على الاقتصادات المدمرة وعلى المجتمعات التي عانى اقتصادها من خراب مدمر ممنهج على مدار عقود من السنوات المتعاقبة. إن تسجيل الارتفاعات المهمة على معدلات الفائدة في اقتصاد ما، يترتب عليه، وكبديهية اقتصادية معروفة، انخفاض الأسعار بفعل انخفاض الطلب جراء انخفاض السيولة الموجودة بين أيدي الأفراد والشركات على السواء، ويتزامن كل ذلك مع انخفاض حقيقي (على مستوى المؤشرات الحقيقية) لمعدلات التضخم في البلد المعني.
لننزل قليلاً إلى أرض الواقع. لقد حافظ البنك المركزي السوري على معدل لسعر الفائدة يمكن وصفه فعلاً على أنه حديدي! لقد صمد سعر معدلات الفائدة للبنك المركزي للحكومة السورية (ومعه كل المصارف الخاصة) عند معدل 7% منذ بدء الانتفاضة السورية وتحولها إلى حرب أهلية مروعة ترتب عليها تدمير كامل للبنى الاقتصادية على المستويات كافة. وعلى مدار أكثر من عشر سنوات بقي معدل الفائدة ثابتاً، إنه معدل الـ 7%. انهار الاقتصاد، خسرت العملة قيمتها إلى درجة أن قيمتها لم تعد تغطّي تكاليف طباعتها الورقية! ومعدلات التضخم الوهمية والحقيقية تجاوزت 200%، وارتفاع الأسعار وصل معدلات انهيارية حقيقية (أكثر من ألف ضعف وعلى أكثر البضائع أساسية ومركزية)، رغم كل هذه المؤشرات التي لا تعني شيئاً أقل من انهيار كامل لكل بنى الاقتصاد السوري وصولاً إلى حدود مجاعة (أي العودة إلى ما يمكن تسميته بالاقتصاد البدائي!)، رغم كل ذلك، هناك شيء واحد بقي وبغرابة شديدة صامداً، إنه معدل الفوائد للمصارف الخاصة والعامة على الأموال المودعة.
لن ندخل في تفاصيل التحليلات الأكاديمية لهذه الظاهرة الغريبة (رغم حاجتنا إليها فعلياً، فالدراسات الأكاديمية عن الاقتصاد السوري قليلة وغير كافية)، ولكن، ومن أجل وضع فهم مبدئي لها، فإن الحكومة السورية والقيادة الاقتصادية والمالية للحكومة السورية، كانت قد اختارت خياراً صارماً، منذ بداية الحرب ومنذ بداية الانهيار، بأنها سوف تضع كل أعباء الانهيار الاقتصادي والخسائر الاقتصادية كلها على أكتاف القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السوري، صناعية وتجارية...إلخ، شركات وأفراداً، وأنها لن تمس مصالح القطاع المصرفي والمالي ومكاسبه وأرباحه بحال من الأحوال ولن تسمح له بالتضرر أبداً من الخسائر المروعة الانهيارية التي يتعرض لها هذا الاقتصاد. التثبيت الحديدي لمعدلات الفائدة كان يعني شيئاً واحداً: القطاع المصرفي والمالي السوري لن يشارك أبداً في تحمّل الخسائر، ولن يترتّب عليه أي عبء جوهري من أعباء اقتصاد الحرب المتداعي.
إنه قرار كان قد حدد جوهر السياسات الاقتصادية على مدى عقود الحرب المريرة القاسية: إن الذي سيسدد فاتورة الخسائر هو القطاعات المنتجة. عبر الضرائب والجباية ثم عبر التشليح المباشر والأمني (وهو أسلوب طبيعي عند عرابي صيدنايا وأقبية سجون المزة عبر ما سمي بفرع الخطيب وغيره). وعندما نقول القطاعات المنتجة فالخاسر الأكبر هو القطاعات الواسعة من الشعب السوري. الشركات والأفراد وكامل الطبقة الوسطى تحولت، عبر بضع سنوات قليلة فقط، إلى ركام! لقد تحولت إلى بقايا قطاعات اقتصادية فاعلة أو عاملة ولم ينجُ منها إلا نخبة متعاونة متحالفة فقط، استطاعت التعامل، أو بالأصح النجاة، بسبب قربها من السلطة وعلاقات الانتفاع المتبادل.
التوجهات الاقتصادية اليوم ترسم مستقبل السلطة الجديدة في سوريا، وموقفها المركزي الرئيسي سيكون من نخب القطاع المصرفي والمالي، وهو سؤال بسيط ومختصر ومركز وشديد الوضوح: مصالحهم أم مصالح الاقتصاد السوري؟ إذ إن بين القطبين علاقة تناقض واضحة.
* كاتب سوري